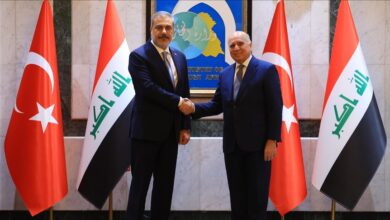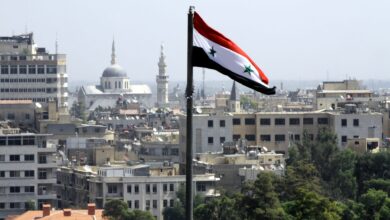هل ستقود السويداء قاطرة التغيير المرتقب في سوريا؟

محمد عيسى
في ظل أزمة سورية تتصاعد فصولها كل يوم وتتشابك أبعادها وجوانبها؛ تبرز أحداث السّويداء وما شهدته الأحد الماضي من احتجاجات شعبية، مترافقة بأعمال عنف سقط بنتيجتها ضحايا سوريّون من المدنيّين المحتجّين وفي صفوف رجال الأمن، وتبرز معها حقيقة بديهية تؤكد أن الأزمة السورية بمجملها قد دخلت طوراً جديداً، وأصبحت السلامة الوطنية والاستقرار على درجة فائقة من الدقة والخطورة.
والموضوعية في الحكم عليه؛ تستدعي تسليط الضوء على التربة التي نشأ فيها هذا التطور وعلى بيئته، بمعنى المدى الذي توفرت فيه الشروط الموضوعية والذاتية لحصول بداية انفجار اجتماعي، قد يتطور إلى مستويات أعلى وأشد حسماً. وفي هذا الإطار، ونحو الشروط الموضوعية بالذات، لا يجادل أحد بأن الحياة في عموم الأراضي السورية وليس في السويداء فقط، قد أصبحت جحيما لا يطاق، حيث تعاني مناطق عديدة كمناطق الساحل السوري وبعض المدن، من تراجع الخدمات وشُحٍّ مهول بالمحروقات، مع انقطاع شبه دائم للكهرباء، يترافق مع ارتفاع كل ساعة في أسعار السلع الأساسية، وانتشار للفوضى في كل شيء، في ظل غياب متزايد لدور الدولة، ويتجلى ذلك بتخليها عن وظائفها الأساسية، حيث تتفرد الحالة السورية بظاهرة اقتصادية لا مثيل لها في العالم، تتجلى بأنه رغم أن غالبية العمالة السورية هي عاملين لدى الدولة، وهؤلاء جميعاً، من الآذن في الدولة وحتى رئيس الحكومة، يتقاضى راتباً لا يكفيه سوى لثلاثة أو أربعة أيام، في أقصى الحدود، ومع ذلك يستمر مع ما يعنيه ذلك من استشراء للفوضى والرشوة والفساد والتحلل وانسداد الأفق أمام المواطن البسيط والموظف الشريف، الذي يضطر إلى أن يعمل كذا عمل خارج أوقات دوامه. وما يجعل كتلة كبيرة من السكان تواجه مجاعة حقيقية وتنقّب في حاويات القمامة عمّا يَسُدُّ رمقها. وكتلة أخرى تأكل قليلاً وتدفع يومها دفعاً، أو تكاد تتخلص منه. يجاور هذا التموضع الاجتماعي المزري؛ نسق من أثرياء، لصوص أثروا بفعل استغلال نفوذهم في الدولة والحكومة.
والأمانة في التقييم هنا، تقتضي التنويه إلى أنه لا يوجد في هرم التموضعات الطبقية في سوريا طبقة رأسمالية حقيقية من أي نوع أسوة بباقي الدول. ووفق معايير نظام الاستثمار الرأسمالي المتعارف عليها بالاقتصاد، حيث تتولد فيه طبقة أثرياء استثمرت أموالاً وأصولاَ اقتصادية وكسبت أرباحاً ودفعت ما يترتب عليها من ضرائب للدولة، بل يكاد يوجد محض لصوص فقط وأثرياء جدد ليس لهم جذور اقتصادية، وقد جمعوا أموالهم من وجودهم كموظفين نافذين في مفاصل الدولة، أو أصحاب امتيازات حصرية في مجال التجارة الخارجية، أو كمقترضين من البنوك الحكومية على ذمة مشاريع وهمية ومتحايلين بطرق التسديد ومن سعر الصرف وغير ذلك، أمثال رامي مخلوف والقاطرجي أو فوز وغيرهم.
فهذا النهب الجائر لموارد الدولة والمجتمع، مضافاً إليه مفاعيل العقوبات الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي، كقانون قيصر، والمترافق مع تلكؤ أو عجز من قبل الحلفاء في روسيا أو إيران عن تعويض النقص، مع فشل السياسة الاقتصادية المزمن، كحالة منطقية في كل النظم الشمولية، تسبب في خلق واقع موضوعي يقرب المجتمع في السويداء وفي غيرها من حالة الانهيار وانتشار الفوضى والجريمة. فالسرقة في كل حقل من حقول الحياة، أو الانفجار الاجتماعي على طريق ثورات جياع؛ تكنّس في طريقها كل شيء. فالعامل الموضوعي متوفر ومستحق، منذ وقت ليس قليل. بقيت المشكلة الأهم والأخطر على المجتمع السوري وعلى مستقبل الوطن السوري والدولة؛ هي في توفر العامل الذاتي أو نضجه لإحداث التغيير التاريخي السلمي والمنشود.
فالعامل الذاتي الذي يدفع أو يوجه ويستثمر في الشروط الموضوعية، بمعنى توفر الطليعة السياسية الواعية، فهي غائبة غيابا لافتاً، ويكاد يكون غياباً فريداً من نوعه، وذلك لأسباب عديدة؛ على رأسها طبيعة النظام الشمولي. ففي النظم الشمولية لا تتحقق ثنائية “نظام في مقابل شعب”، بل يتماهى النظام مع الشعب، ويصبح كل الشعب مشمولاً بالنظام أو شريكاً فيه، بطريقة أو بأخرى، عبر تعبئة الناس في المنظمات الشعبية أو النقابات أو أحزاب السلطة ومؤسساتها الأمنية، حيث جميع النقابات والمنظمات في دساتيرها ما يشير إلى أنها تنظيم اجتماعي هادف مرتبط بتحقيق أفكار الحزب الحاكم، ويندر أن تجد مواطناً في الحالة السورية ليس عضواً في نقابة أو منظمة شعبية واحدة أو اثنتين، على الأقل، من تلك التي يقودها حزب البعث الحاكم، وفي مثل هذه الحالة سيكون من السذاجة انتظار أي فعل واعٍ أو ناضج نحو التغيير الإيجابي، بل سيكون المجتمع صدى مقيتاً للنظام الشمولي وسيحمل أسوأ أمراضه، وسيدور الأمل على النظام نفسه، وسيكون النظام ونخبه متفوقاً على المجتمع وأكثر تأهيلاً منه للنهوض بأدوار منتظرة. فالمجتمع – للأسف – يُعَدُّ في هذه الحالة مسخاً عن النظام ولا يتحرك إلا بأمرته ويحمل أشد أمراضه.
تأثير العامل الإيراني والروسي يساهم في تشكيله أو تأخير نضجه، حيث يسعى الفريقان، وكل على حدة، ليس فقط على تكريس مصالحه واستئثاره بموارد البلاد ومرافقها الحيوية؛ بل أيضاً في تعميم نموذجه في الثقافة وفي الإدارة وعلى صعيد القيم والأخلاق، ما أنتج حالة سورية مركّبة وعجيبة، لنموذج مافيوي في كل نشاط وكل زاوية، بدءاً بمواقع النفوذ والإدارة، وانتهاء بالمؤسسات الدعوية وخطباء المساجد، إلى حد جعل منه نذير شؤم عند السوريين وعامل إحباط لأي أمل في إجراء إصلاح أو تغيير، ويمكن القول، دون تردّد، بأن كرهاً متنامياً لدور هذا الفريق عند السوريين الواعيين بدأ ينتشر بوتائر متسارعة.
الإسلام السياسي كمشروع إيديولوجي للشعب السوري والذي غذته وجذرته توجهات الصراعات الدولية خلال العقود الماضية، واستفاد في العقدين الأخيرين من انفلات المشاريع التركية والفارسية، والتي تحكمت بعقل الشعب السوري وسجنته مقيداً بقيود وضوابط القرن الهجري الأول أو الثاني، في أحسن تقدير، وفي السياق نفسه، يجدر أخذ الحيطة والحذر الشديد من مخاطر يحملها الخطاب التركي، وبالتالي المشروع التركي ليست ذاتها في المشروع الإيراني، حيث يلتبس المشهد على بعض النخب وفئات الإنتلجنسيا من النجاحات الاقتصادية المتحققة وبعض المناخات الديمقراطية التي سادت مع النموذج التركي، والتي جاءت بفعل الاصطفافات التركية إلى جانب الغرب في العقود السابقة، وبفعل ما خلفته سياسات الحكومات العلمانية الأتاتوركية من ظروف، جعلت من تركيا نموذجاً خاصاً، وإلى حين.
وبالعودة إلى تظاهرات السويداء، وإلى العبر والدروس التي يمكن التقاطها في هذه اللحظة الدقيقة التي تمر بها البلاد، فيمكننا أن نلاحظ أن السويداء ليست استثناءً وليست حدثاً منفصلاً، فالنظام الشمولي المأزوم، ولمجرد خلوّه من بعض المناطق في الجغرافيا السورية، كانت على الدوام تخلفه على الأرض تشكيلتان من القوى، يتحدد حجمها ودرجة انتشارها ونفوذها تبعاً لتأثير العوامل الخارجية والإقليمية، الأولى إسلاموية تعتمد العنف والإرهاب طريقاً، ويتركز انتشارها اليوم في إدلب ومناطق شمال غرب سوريا، وتحظى بدعم وتأييد تركيين، وقوى مدنية علمانية وذات نزوع ديمقراطي ثوري، تحاول التمحور حول الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية، إلى حد كبير. والنموذجان وتعبيراتهما السياسية لم يكونا بعيدان عن النظام وتركيبته، بل نشأ الاثنان في رحمه وحملا الكثير من نزعاته، وكانا أجزاء أو احتمالاً فيه، لأنه في كنف الاستبداد الشمولي تختبئ النزعات الحدية، وتتلطى خلف نزعات النظام الوسطية، ما يعني أن أطراف الفعل الوطني ما زالت تجد لها ظهيراً حقيقياً في النظام، وأن النظام ليس كتلة صمّاء، بل كوكتيلاً متشابكاً من قوى طبقية واجتماعية متناقضة.
ويمكن للقوى الغيورة على مصلحة البلاد والطامحة إلى اخراج الدولة والمجتمع من مأساته ومن تعقيدات وصراع مصالح الدول المتدخلة، وبالمثل، على القوى التي خرجت عن مظلة النظام أيضاً أن تدرك وأن تستنفر الهمم إلى عمل وطني مشترك بوابته الحتمية الحوار الشامل والمراجعة في كل شيء، وعدم تفويت أي فرصة في إتمام اللقاء الوطني على أساس المشتركات الوطنية للجميع، وعلى قاعدة نفض اليد من القوى الخارجية، دون استثناء، فبالنهاية الأمريكي والروسي والتركي والإيراني والإسرائيلي، كلهم سواء بسواء أصحاب أجندات ومصالح ولا شأن لهم بمصير السوريين ومستقبلهم. ولأن كان بعض الناشطين في السويداء قد طلبوا من الوفد الروسي الذي زارهم بقصد إيجاد حل للاحتقان الحاصل مغادرة المنطقة؛ فإن الأمر نفسه يجب أن يجري في كل مكان من الأراضي السورية.
الآراء المنشورة في المنصة تعبر عن وجهة نظر كتابها..