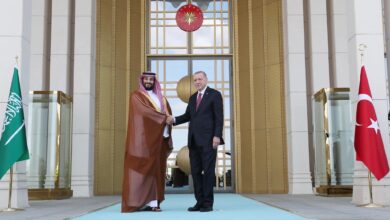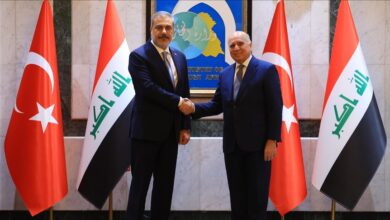هل أنتج محور أستانا حلا للأزمة السورية أم أزمات؟

محمد عيسى
هو نفس السؤال مازال يكرر نفسه على ألسنة السوريين منذ نشوب مأساتهم قبل ما يزيد على عقد من الزمن وإلى الآن؛ إلى اين؟ ما الحل بالنهاية؟ ماذا يحمل لنا هذا العام؟ ماذا يقول ميشيل الحايك أو ليلى عبد اللطيف؟ فعلى هذه الدرجة من الإحباط وانسداد الأفق؛ باتت حال المترقبين لبزوغ ضوء في نفق الأزمة، وحال المتابعين والمهتمّين على جميع المستويات. تستوي في ذلك نظرة رجل الشارع مع مقاربة المحلّلِ في مراكز البحث، مع تصوّر رجل الدولة وصُنّاع القرار في أكثر الأحيان. وليس أدلُّ على هذه الصورة أكثر من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش قبل ما يقرب من شهر، حين ذهب ليقول “إن الأزمة السورية والحرب الأهلية ما زالت عند نقطة البداية، والأرض السورية مفتوحة على احتمالات نشوب حروب عديدة”.
ولمحاولة فهم هذا الاستعصاء وهذه المراوحة الحاصلة في المعضلة السورية؛ لا بد من العودة إلى التأمل بظاهرة “الربيع العربي” في لحظة ولادتها، وحيث إن الأزمة في سوريا كانت إحدى محطاتها. وبصرف النظر عن الدواعي الاجتماعية والظروف الموضوعية التي كانت تستدعي حصول انفجارات في الوضع الاجتماعي للدول والمجتمعات العربية، ومع الأخذ بعين الاعتبار تهالك البنى الاجتماعية والسياسية القائمة في عموم الدول التي شهدت حراك ما سمي بـ”الربيع العربي”، وجوع الشعوب إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والذي يخلق بدوره مبرّراً تاريخياً للثورة وحركات التمرّد؛ إلا أنه لا بد من التيقُّن من ملاحظتين:
الأولى؛ أن هذا الربيع لم يمر على كل الدول في المنطقة، وقد حَيَّدَ طريقه عن الدول التي كانت محكومة – وما زالت – بنظم ملكية محسوبة تاريخياً على أمريكا وحلف الغرب، كالسعودية وإمارات الخليج، فالأردن ومملكة المغرب. وإذا كان قد مَرَّ على تونس ومصر؛ فقد كان وقعه خفيفاً.
والثانية؛ هي أن الدول التي عبرها هذا القطار كانت من نموذج الدول التي دعيت بالدولة العروبية التوتاليتارية وذات النزعة الثورية، والتي كانت تُصنَّفُ معادية لما يسمى الإمبريالية، وحيث سمح نسيجها الاجتماعي أو هي فشلت بتحصينه إزاء اندفاعة كبيرة للمشروع الإسلامي الإيراني والتركي، على نحو كبير.
سوريا، ولسوء طالع السوريين، كانت من دول النموذج الثاني التي عانت من تغوُّلِ المشاريع الإقليمية وتنافسها وأحياناً تصارعها، على حساب أرضها وسلامة شعبها. وفي هذا الإطار يمكن أن نفهم دوّامة العنف في اليمن وليبيا ولبنان والعراق، حيث أصبحت مناطق نفوذ تركي وإيراني، وأخيراً روسي بامتياز.
وقبل كل ذلك، وبمعزل عن المخططات والمشاريع الإقليمية والدولية التي حتَّمها موقع سوريا الجغرافي المتاخم لتركيا وإسرائيل؛ فمن الواضح أنها قد عانت من أعراض أزمة بنيوية حادة، في ظل نظام شمولي سيطر على حكم البلاد لحقبة طويلة، كان من مفاعيلها غياب دور المجتمع المدني، وخلق معارضة ضعيفة ومشوَّهة، وفي الغالب قد سارت حينما وجدت في ركاب الحركات الإسلامية أو تواطأت معها، الأمر الذي فرض نفسه على ماهية الحراك الاجتماعي الاحتجاجي الناشئ مع موجات الربيع العربي مطلع العام 2011، ومن ثم تطييفه وعسكرته لاحقاً.
وبعده جاء التورط الإيراني، عبر أذرعه في البداية، والتركي عبر حركات الإسلام السياسي وتنظيماتها الإرهابية. هذا التورط الذي لم يحقق للسوريين شيئاً غير تحويل بلادهم إلى ساحة حرب وتنافس على النفوذ والسيطرة، مما هدد وحدة البلاد والمجتمع وكاد يقوض الدولة السورية، لولا تدخل الروس في اللحظة الأخيرة، ما أعاد للدولة كثيراً من التوازن، وللصراع معدَّلاً وازناً من ضبط الإيقاع. وحيث نجح نظام دمشق، بمعونة الروس والإيرانيين، باستعادة جزء كبير من مساحة البلاد، وكذلك بطرد التنظيمات الإرهابية كـ”النصرة وداعش” وغيرها من معظم المدن والمناطق، ولينحصر نفوذهم أخيراً في إدلب وبعض المناطق القليلة.
وإلى ذلك؛ يُسجَّلُ للروس بعد تدخلهم في سبتمبر/ أيلول 2015، أنهم قد حققوا نسبياً، أو يمكن القول نجاحاً تكتيكياً، أدى إلى إضعاف نفوذ الإسلاميين وتراجع دورهم في تحديد مستقبل البلاد، والذي كان نفوذاً طاغياً ويكاد يكون وحيداً؛ لخلافة النظام فيما لو سقط.
وثمة نقطة لافتة في تطور الصراع؛ تتمثل بحصول نقلة نوعية بالعلاقات الروسية – التركية بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية من قبل الطائرات التركية مع بدء التدخل الروسي، والتي تُعَدُّ الحادثة اليتيمة، والتي قادت إلى تقديم اعتذار تركي رسمي قدَّمه أردوغان إلى الرئيس بوتين، ثم قاد هذا الاحتكاك إلى بدء حوار، فصداقة، فتمحور، ضَمَّ بالإضافة إليهما إيران وشكَّلَ محور تعاطى مع الأزمة السورية تحت مسمى “محور أستانا”، وسُوِّيَت أغلب نقاط التشابك الحادثة على المسرح السوري بناء على تفاهمات ومقايضات جرت من بين أدراجه.
ويمكن الجزم دون الوقوع بخطأ كبير؛ بأنه حتى وقت قريب قد نجح التدخل الروسي في نيل نوعٍ من الرضا الأمريكي والإسرائيلي، وبأن تنسيقاً عالي المستوى كان يدور بين الأطراف الثلاثة، ويأتي على رأس عمليات التنسيق؛ اللقاء الهام قبل ثلاث سنوات في القدس لرؤساء مجالس الأمن القومي، الأمريكي والروسي مع الإسرائيلي، وقد تبعته بين لقاءات أخرى عديدة. ما أوحى بوجود نوع من التفويض الروسي من قبل الأمريكان بإدارة الملف السوري. وأبدى الأمريكان الكثير من الصمت حيال مجازفات محور أستانا وتلكؤه في حل الأزمة السورية، أو محاولة حلها على طريقته، عبر تكريس الواقع القائم أو إعادة استنساخه من جديد.
لكن ومع نشوء الأزمة الأوكرانية الروسية وتصاعد أتون الحرب وتطورها إلى مواجهة تكاد تكون مباشرة بين دول الأطلسي وروسيا، تغير الموقف كثيراً، وأصبحت الساحة السورية امتداداً موضوعياً، وإن بشكل غير معلن، لساحة الصراع في أوكرانيا، ما انعكس في تعقيد الأمور وبروز زيادة في الاهتمام والتدخل الأمريكي في الوضع السوري.
أمّا حيال الدّور الأمريكيّ والنأي بنفسها عن طرح حلول عمليّة، وتأثيرات هذا الدَّور؛ يقفز إلى الذهن سؤال حول التصور الروسي للحل، وبالتالي تصوّر محور أستانا للأزمة برمتها، ثم الفكرة الأهم من كل ذلك؛ هل يوجد أصلا مشروع للحل في جعبة أستانا، وإذا كان موجوداً، ما هي طبيعته، وما هي الخطوات المتّبعة لتطبيقه، وما هي المعوّقات التي تحول دون تحقيق تقدم في الطريق إلى بلوغه، وما هو موقف الشعب من هذا المشروع للحل، ونظر ة المشروع ذاته لدور الشعب وحقوقه؟ كل ذلك في لحظة، يتضور فيها الشعب جوعاً ويكابد هموماً غاية في الصعوبة، في ظل أوضاع يستأسد فيها فساد غير مسبوق، وفي مناخ تكاد تنعدم فيه أي تدابير لمواجهته، غير شعار الممانعة والمقاومة.
وبالمجمل لم يقدم المحور الممانع في مسمى “أستانا” غير إنتاج الأزمات وتصديرها، وبالتالي سيكون من غير المنطقي التحري عن حلول لأزمة السوريين في سياسة هذا المحور، الذي هو جزء أساسي من المشكلة وليس جزءاً من الحل.
الآراء المنشورة في المنصة تعبر عن وجهة نظر كتابها..