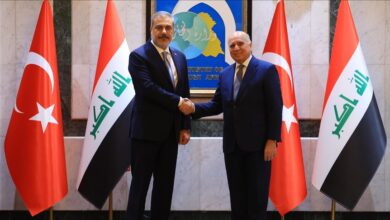رياض الترك.. نزعة “قومية شيوعية” ومسيرة حافلة بالمتناقضات

محمد عيسى
قبل أيام قليلة، قضى في باريس، وعن عمر ناهز الـ/94/ عاماً، القيادي البارز في الحزب الشيوعي السوري “رياض الترك”، والأمين العام للحزب الشيوعي السوري–جناح المكتب السياسي، والذي كان قد تبلور كحزب مستقل على إثر انقسام الحزب الأم في عام 1974 من القرن الماضي إلى حزبين مستقلين ومتعارضين، الحزب الشيوعي السوري–جناح بكداش، والحزب الشيوعي السوري– جناح الترك. هذا الانقسام الذي ظهرت بواكيره ومسائله الخلافية منذ المؤتمر الثالث للحزب الذي انعقد في العام 1969.
القضايا الخلافية تركزت على بعدين، فكري سياسي وتنظيمي. أما الجانب الفكري؛ فإن موضوع الخلاف قد تجلى بإشهار “الترك” لميوله القومية العربية، وفي محاولاته جر الحزب الشيوعي منذ أواخر الستينات إلى تبني شعار الوحدة العربية، والعمل على خدمة شعار “الحزب الشيوعي العربي الواحد”، بالإضافة إلى اعتماده لشعار تحرير الأراضي المحتلة، كرجع صدى لمفاعيل هزيمة حرب 1967.
تلك القضايا والشعارات التي بقيت تردده السنوات وبالخط العريض في جريدة الترك “نضال الشعب”،وتحت عناوين بارزة، وبالتسلسل “تحرير–ديمقراطية شعبية–اشتراكية علمية–وحدة عربية”. ورغم أنها في الجوهر شعارات لم تكن تختلف في الكثير من جوانبها عن تلك التي يتبناها حزب البعث الحاكم بقيادة حافظ الأسد،إلا أنه من الموضوعية الإشارة إلى أن أحد أهم نقاط الخلاف التي جاهر بها “الترك” في عمل منظمات الحزب وهيئاته القيادية، كانت مسألة المشاركة في عمل “الجبهة الوطنية التقدمية”، التي جاء بها حافظ الأسد كتدبير لحكم البلاد بعد وصوله للسلطة في العام 1970. وحيث لم يكن “الترك” ليوافق على ميثاقها الذي كان قد حظر على الحزب الشيوعي وباقي أطراف الجبهة العمل في قطّاعي الطلبة والجيش.
أما الشق التنظيمي من الخلاف؛ فقد كان يدور حول ظاهرتين أو مرضين، الأول عبادة الفرد بالحزب واستئثار “خالد بكداش” بمنصب الأمين العام في الحزب لحقبة طويلة من الزمن، وغياب المؤتمرات في حياة الحزب، الأمر الذي لم يكذّبه هو الآخر. وقد صادق عليه عبر ترشيح زوجته “وصال فرحة بكداش” لخلافته في منصب الأمين العام لما تبقى من الحزب، والتي بدورها قد ورَّثت ابنها “عمار” لنفس المنصب.
والثاني، هو موقف التبعية العمياء للمركز الأممي المتمثل بقيادة الحزب الشيوعي السوفيتي، تلك القضية التي تمسك بها عميقاً واستقوى بها “بكداش” وتفرد بالاختلاف في الموقف منها “رياض الترك”.وحول هذه النقطة قد يكون من دواعي فهم السياق الذي تجري على ناصيته الحوادث التاريخية، أن دوافع “رياض الترك” لتبني مواقف الاستقلال عن موسكو في انتهاج وتبني سياسة الحزب، كانت تجري ضمن مناخ فكري سياسي عالمي تمثل بظهور مفهوم “الشيوعية الأوروبية”، التي تمثلت بثالوثها الإيطالي فالفرنسي والإسباني، والذي استحدث فكرة إسقاط شعار ديكتاتورية البروليتاريا من المهام التاريخية لطريق بناء الشيوعية.
تذهب هذه التوطئة إلى بديهية أنه من المستحيل تناول ظاهرة “الترك”، الشخصية الشيوعية النضالية الملتبسة، وصاحبة أطول تاريخ من الصدام والمعاناة مع نظام الاستبداد، حيث قضى في سجونها إلى ما يزيد عن سبعة عشر عاماً، فهو الشخصية والظاهرة التي لا يمكن الإحاطة بدلالاتها دون المرور على مسألتين لازمتين، الأولى، أن “رياض الترك” بالمعايير الأساسية للماركسية لم يكن ماركسياً خالصاً من جذوره، بل كان في الغالب أقرب إلى التفكير القومي العربي وإلى الإسلامي كما سيظهر في تاريخه اللاحق. واللازمة الثانية؛ هي أن أي مقاربة لشخصية ودور “رياض الترك” تستدعي حتماً الحديث عن “خالد بكداش” نظيره في المواقف السياسية ومثيله في النرجسية السياسية وشريكه في تقويض الحزب الشيوعي السوري، الذي كان حزباً جماهيرياً في خمسينيات القرن الماضي.
إن شأن الحزب الشيوعي السوري شأن الكثير من الأحزاب الشيوعية في بلدان عربية عدة كالعراق مثلاً، فهو يقف على مسافة خطوات قليلة من الوصول إلى السلطة. وتوثق مجلة “النهج، المجلة الناطقة باسم الأحزاب الشيوعية العربية في أحد أعدادها الصادرة في أوائل تسعينات القرن الفائت، أن الحزب الشيوعي العراقي كان قد انخرط في صفوفه في ذلك الوقت ما يقرب من ثلاثمئة ألف فلاح، والحزب في سوريا قد نجح بفضل وزنه الجماهيري بإحراز مقعد أول برلماني شيوعي في العالم الثالث عن مدينة دمشق، وأنه صاحب أعلى نسبة تأييد بين صفوف النساء، هذا الرصيد الشعبي الواسع كان من محفزات رفع وتيرة التآمر على تجربة الحزب الشيوعي في بلاد الشام عامة.وهذا ما سرع عند المراكز الإمبريالية من عجلة الدفع بطبخة من أحزاب قومية ذات جذور طبقية من فئات البرجوازية الصغيرة كالبعث والناصري، لقطع الطريق على المد الشيوعي الذي كان يتنامى صعوداً، ليظهر اسم الشهيد “فرج الله حلو” كعلامة حادة ودالة على حجم ضلوع النهج الديكتاتوري القومي الشوفيني في تنفيذ الخطط الإمبريالية الرامية إلى النيل من عزيمة قوى الديمقراطية واليسار الشيوعي المتصاعد.
وإزاء هذا التطور من تكالب المتآمرين على المد الشيوعي، لم يكن أداء النخب القيادية في تجربة الحزب الشيوعي السوري، ممثلة بنموذج “الترك وبكداش” أقل تورطاً في خلق جو الهزيمة ضمن عمل منظمات الحزب، عبر استبعاد الكفاءات الفكرية والكوادر من ذوي النشاط الإبداعي أمثال المفكر الكبير “إلياس مرقص”، وليبلغ التصحّر الفكري في الحزب أوجَهُ بعد خروج الحزب الشيوعي اللبناني الذي بقي يحظى بنسق مهم من المراجعين والباحثين في الفكر والفلسفة السياسية من صفوف الحزب الأم في سوريا.
إلى ذلك يمكن القول إن كلا الفصيلين “بكداش والترك”، وبفعل العوامل السابقة، كانا قد قادا الحزب من حزب ذي ثقل شعبي وسياسي بارز،إلى شبه باقة صغيرة من شيوعيين منسيين، يتسوّل الأول منصباً وزارياً هزيلاًأو بلدياً عند البعث، والثاني شيئاً مشابهاً عند تنظيم الإخوان المسلمين.
وبالعودة إلى تجربة “رياض الترك” وإلى أصدائها على مسار العملية الوطنية، فيمكن القول إن “الترك” الذي قاد نهجه إلى خلق انشقاق عمودي في الحزب، لم ينجح بالنتيجة بجعله انقساماً ثورياً، بحسب الرؤية اللينينية التي تقول إن أي انقسام في حزب البروليتاريا سيؤدي في الغالب إلى حركتين أو توجهين،أحدهما ثوري والآخر انتهازي يميني.ورغم انشغال “الترك” طويلاً في أشغال موقع الحزب الشيوعي الثوري،أو مكانة الحزب الشيوعي ذي الطراز الجديد، بحسب المبادئ اللينينية، في تحديداتها لمعايير الحزب الثوري، فهو لم يوفق كثيراً في مسعاه، لسببين اثنين، الأول، سيطرة الفكرة الواحدة المنصبّة على أولوية إسقاط النظام كيفما اتفق، ودون مراعاة لتوفر الشروط اللازمة لتحقيق ذلك.والثاني؛ اعتماد المنهج الانتقائي في التفكير وفي السلوك أثناء صوغه لتكتيكاته السياسية، وفي إقامة التحالفات الهادفة إلى إنجاز التغيير الديمقراطي الثوري المنشود، فهو في هذا المسلك ضد النظام الشمولي الاستبدادي والقومي البعثي في دمشق حتى العظم، ومن جهة أخرى يمد أمتن جسور التواصل والتعاون مع نظيره البعثي الشوفيني في العراق، تلك الجسور التي أقامها مبكراً القيادي في الحزب ومبعوث “الترك” الدكتور “محمد محفل”.
وعلى هذا النحو أيضاً، وبالانطلاق من مُسَلَّمة تفكيره القومي الضيق ذي النسخة الإسلامية والذي لم يخفه يوماً، فلم ينبت ببنت كلمة إدانة حيال إجراءات “صدام” بحق الكرد وفي مجازر الأخير في “حلبجه” الكردية، في الوقت الذي يسود فيه انطباع عام مؤيد لحق الكرد في تقرير المصير عند مجمل فصائل اليسار العربي وقوى حركة التحرر العربية، وليس هذا هو التناقض الوحيد؛ بل يسجل عليه رفضه إدانة مجازر الإخوان المسلمين بحق كثير من الأبرياء السوريين من الطائفة العلوية والأقليات الأخرىذي المسحة الإسلامية.
وعلى خط الأزمة السورية، ودائماً في عبور نفق التحالفات، ورغم الصلابة المشهودة للرجل في مواجهة طغيان آلة القمع والاستبداد؛ فإن من نافل القول إن الرجل كان مهووسا بنزعة جر الإسلام السياسي الإخواني إلى لعب دور وطني، وكان صادقاً في تأملاته ورغبوياً إلى حد كبير. فهو ومنذ أزمة الإخوان الأولى في ثمانينات القرن الماضي، ومنذ أن ألبس حراكهم الفئوي المشبوه في أعقاب اتفاق “كامب ديفيد” لبوس “الانتفاضة الشعبية ضد نظام لا وطني”، وهو يكرر الرهانعلى دور شعبي طبقي كفاحي يمكن أن تلعبه القاعدة الشعبية للإخوانبصفتها على المستوى الطبقي قد تكون مهمشة ومضطّهَدة ومؤهلة نظرياً لأن تنهض بمهام ثورية، لكن كان يفوته دوماًأن هذه الطاقة الثورية المحتملة والتي كرر التعويل عليها في نظرته إلى الأزمة السورية الأخيرة هي طاقة ناضبة، لأن قيادة الحركة مشبوهة بظروف نشأتها وبولاءاتها اللاوطنية لخارج الحدود، ما يجعلنا في هذه المقاربة أقرب ما نكون في تقييمنا للتموضع الطبقي لفئات المهمشين الإسلاميين،أقرب إلى نعت البروليتاريا الرثّة التي ضلَّت طريقها ويسهل توظيفها بما يتعارض مع مصالح طبقتها.
أما من يحاول أن يجد نقاط تقاطع ما بين تجربة الحزب الشيوعي السوداني في تعبئته لفئات الإسلاميين الفقراء، ومابين خطا جماعة “الترك”، فلم يصب، وهنا الفارق كبير لتجربة “عبد الخالق محجوب” التي كانت تحمل ملامح إبداعية، لجهة العمل مع القاعدة الشعبية الإسلامية المتدنية، وارتياد المساجد للتعايش معها، بقصد رفع مستوى وعيها وتثويرها، ولم يكن العمل مع أنساق على شاكلة “البيانوني وطيفور”، ولم تكن تكتيكات الحزب الشيوعي السوداني لتصل إلى حد المجازفة بإقامة أوثق العلاقات مع مراكز الإسلام السياسي في أنقرة وإسطنبول، هذه العلاقات التي كان ثمنها الأولي بخساً، وقد يكون سقفه تعيين “جورج صبرا” في موقع رئيس “المجلس الوطني الإخونجي” البناء، مقابل تحول الحزب، حزب “الترك”، حزب الشعب الديمقراطي إلى شاهد ليبرئ جرائم الإخوان ومرشديهم في تركيا وقطر.
وعموماً ولطالما كنا مانزال في طور التقييم والمراجعة لتجربة رجل بحجم “رياض الترك”، لا يسعنا إلا أن نذكر بأن ماذهبنا إليه من آراء حول الثغرات، التي اعتورت تاريخ وتجربة “الترك”، كان هو من أقر بها في العام 2019، في مقابلته الشهيرة مع الصحفية الراحلة “جزيل خوري”، والتي لخصها باعترافين كبيرين، بقوله “لقد فشلنا بإسقاط النظام، وفشلت ثورتنا ضده لارتكابنا خطأين، الأول رهاننا على الإسلاميين، والثاني نقل مهام قيادة الثورة إلى خارج البلاد”.
وأياً تكن أخطاء الرجل؛ فإن في تجربته من عوامل الصلابة والتضحيات وحسن الظن بحركة الجماهير، ما يجعله يستحق الورد والكثير من التقدير.